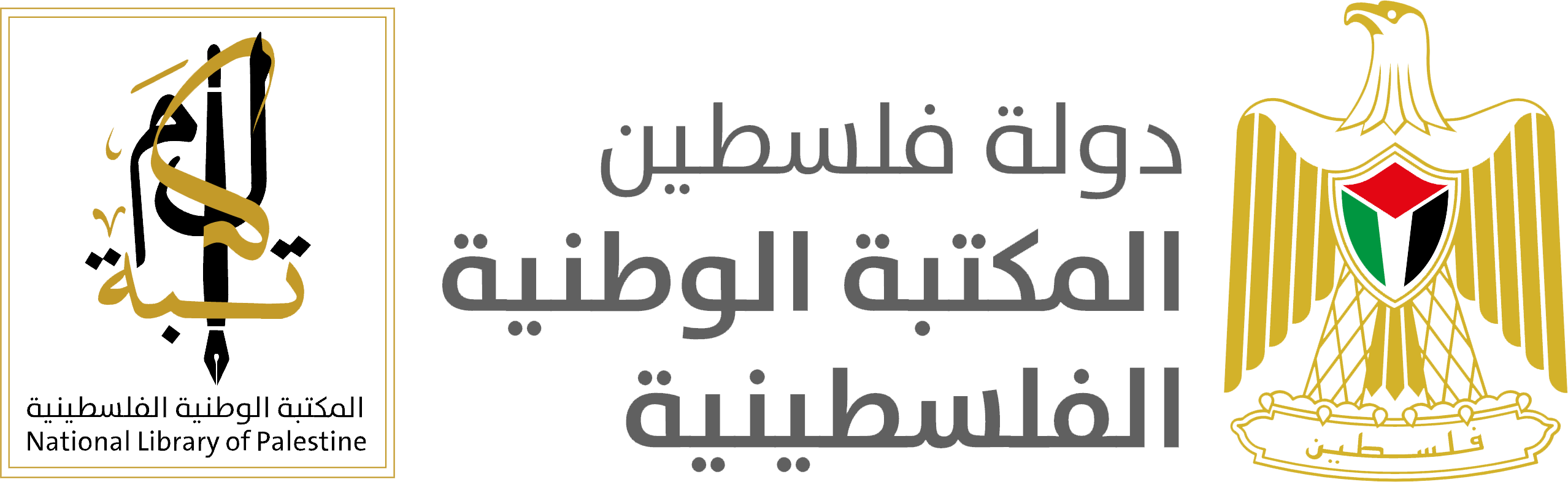د. ضرغام غانم فارس
ملخص
رغم أن الخرافات والأساطير هي الجوهر الأيديولوجي للحركة الصهيونية، إلا أن هذه الحركة العنصرية استطاعت العمل بشكل منظم ومدروس على ترويج أكاذيبها وأهدافها ونجحت الى حد كبير في تقديمها كحقائق تاريخية وإرادة ربانية. لكن هذا النجاح ليس معجزة أو قدرات خارقة للحركة الصهيونية، وإنما هو استفادة مما أنتجته إصلاحات الكنيسة ابتداء من القرن الرابع عشر الميلادي من بيئة دينية ثقافية حاضنة للروايات التوراتية في أوروبا وأميريكا، خاصة المتعلقة منها بشعب الله المختار وارتباط اليهود عرقيا بسلالة يعقوب وصولا إلى سام بن نوح (السامية)، وبالتالي وجوب عودتهم إلى فلسطن. وأيضا هو استكمالا لجهود سابقة كانت تنادي بهجرة اليهود الى فلسطين، وهو انخراط بمشاريع الدول الكبرى الرامية للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط. استطاعت الحركة الصهيونية ثم دولة الاحتلال أن تبلور رواية رسمية واحدة موحدة مكتملة رغم التناقض الواضح في النصوص التوراتية ، وعلى الرغم من تناقض روايتها مع المعطيات التاريخية والآثارية. فيبدوا أن زعماء الحركة الصهيونية أدركوا منذ البداية أن التناقض والتردد يؤدي الى الشك والتشكيك ، وأن الثبات على رواية واحدة مقبولة من طرف المؤمنين بالعهد القديم وتكرارها يؤدي إلى قَبولها وانتشارها رغم زيفها. وبعد قيام دولة الاحتلال استمرت على النهج نفسه وتكرار المزاعم والأكاذيب ذاتها، وهذا يُظهر جليًا أهمية الرؤية الواحدة لقيادة المؤسسة الرسمية وأهمية المواقف الموحَّدة للسياسيين والدبلوماسيين في المؤسسة الواحدة. وهنا أتساءَل: أين نحن -قيادة ومؤسسات أكاديمية وشعب- من هذا العمل المنظم الذي انتهجته الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال؟، وفي ظل نجاح الحركة الصهيونية بترويج الأكاذيب والخرافات، ألا نستطيع نشر الحقائق العلمية وترويجها؟، وإذا كان هناك خلاف بين المؤرخين وهواة التأريخ والمأجورين الذين يتعمدون التضليل، ألا نستطيع الدفاع عن تاريخنا وعن قضيتنا العادلة من خلال الخروج بقراءة علمية واحدة موحدة مكتملة لتاريخ فلسطين فتُعتَمَد على الأقل من طرف القيادة السياسية وكافة السياسيين والدبلوماسيين الفلسطينيين؟ نعم نستطيع، ولدينا قراءة علمية لتاريخ فلسطين أجمع عليها كبار المؤرخين والآثاريين على مستوى العالم، ونستطيع تقديمها للعالم بكل ثقة وجرأة لأنها علمية محايدة وتنقض المزاعم الصهيونية وتنصف قضيتنا العادلة. ولهذا أقدم في هذه الورقة المادة التاريخية العلمية المبسَّطة اللازمة لكل سياسي ودبلوماسي فلسطيني، وهي مادة تقدم صورة مكتملة لتاريخ فلسطين، علمية الإطار والمضمون وبلغة بسيطة تناسب غير المختصين بالتاريخ والآثار، وتنقض مرتكزات الفكر الصهيوني الخرافي مثل السامية والرابط العرقي، وأيضا توضح كيف كان ظهور الديانة اليهودية في فلسطين تطورا في نظام الحكم وفي مفهوم الإله وأنه تطورًا محليًا أنتجه السكان الأصليون متعددو الأعراق وليس طارئًا دخيلا جاء من العراق (إبراهيم)، ولا غزوا جاء من مصر (يوشع بن نون). يجب أن نتصالح مع تاريخنا ونقرأه بطريقة علمية محايدة بعيدًا عن التربية الدينية والتعبأة العرقية التي تهيمن على طريقة تفكير معظمنا، عند ذلك سندرك أن كل ما شهدته فلسطين منذ العصور الحجرية الى اليوم من حضارات وأحداث هو تاريخ أجدادنا وهو موروثنا الثقافي بكل مكوناته الملموسة وغير الملموسة. الكلمات المفتاحية: الأيديولوجية الصهيوني، رواية الاحتلال، السياسي الفلسطيني، تاريخ فلسطين، آثار فلسطين. Abstract In spite of the fact that the ideological substance of the Zionist movement is based on myths and legends, the movement was able to work with structured engagement to promote its lies and goals, and so has been largely successful in presenting them as historical facts and as God's Will. However, this has never been due to a miracle, or supernatural power of this movement, but the exploitation of the church reforms, which has begun to appear since the 14th century, produced later a cultural-religious environment in Europe and America, which embraced and strengthened the concept of the chosen people to God, and the ethnic link of Jews with Jacob Dynasty, as well as to Shem, the son of Noah (Semitic), so to support their return to the land of Palestine. Most notably, these efforts were already an extension of previous attempts, appealing to the Jews to immigrate to Palestine, also is an involvement with the great powerful countries, aiming to control the Middle East. The Zionist movement and the occupation state were able to materialize a consolidated, official, and complete narrative, despite all the clear inconsistencies in the biblical texts, and despite the contradictions in these narratives, compared with the historical and archeological facts. It seems that the Zionist movement leaders recognized that any gap or hesitation would definitely lead to doubt and questioning their narrative. Whereas, insisting on their narrative even fabricated, but accepted by the Bible believers, will be widely reachable and spreadable. Afterward, with the creation of the occupation state, the same approach, allegations, and lies continued. This explains the importance of adopting one consolidated official position and vision for both political and institutional leadership. So I wonder here about our position, as leadership, academic institutions and inhabitants, facing this structured activity of the Zionist movement and occupation state? Are we able to publish and promote scientific facts versus the successful promotion of lies and myths by the Zionist movement? Despite the controversy between historians, amateurs, and mercenaries who intend misleading, Are we able to defend our History? Our case ? by a consolidated scientific and complete history of Palestine, to be adopted at least by the political leadership and Palestinian politicians and diplomats? Yes, Sure we do have a scientific frame of Palestine history, agreed by the most known historians and archeologists all over the world, which we can confidently present worldwide because of its scientific and objective basis, which can also reject the Zionist allegations and will bring justice to our case. Therefore, I present in this paper, a simplified historical and scientifical data, needed for all Palestinian politicians and diplomats. This informative data provides a complete image of Palestine history, as a scientific frame and content, in a simple language to suit all individuals, unspecialized in history or archeology, and to disprove the pillars of the mythical Zionist thought; like Semitic, and the ethnic link. It also tells that the emergence of the Jewish religion in Palestine, had never been a surprising intruder coming from Iraq (Abraham), neither an invasion from Egypt (Joshua), but a meaning of local development of the regime, and of the concept of God. Lastly, we must come to better understanding with our history, we must use the neutral scientific method to read our history, away from the religious education and ethnic incitement. Thereby, we'll recognize that the civilizations and events that Palestine has been witnessing since the Stone Age till now, consist of the history of our ancestors, and form our current tangible and intangible cultural heritage. Keywords: Zionist ideology, Occupation narrative, Palestinian politics, History of Palestine, Antiquities of Palestine. مقدمة: ليس مطلوبًا من السياسي الفلسطيني أن يكون مؤرخًا أو آثاريًا، ولكن يجب أن يمتلك من المعلومات ما يكفي للرد على المزاعم الصهيونية، ونقضها، وليس مطلوبًا منه دراسة تفاصيل الأحداث وما يتعلق بها من لقى وشواهد أثرية، ولكن يجب أن يعرف الإطار العام لتاريخ فلسطين وأهم المحاور التاريخية لمختلف العصور ويقدمها بلغة بسيطية يفهمها غير المختصين وبمضمون علمي صحيح. وحين نتحدث عن السياسي الفلسطيني ندرك تمامًا أن هناك قيودًا سياسية ومحاذير دينية واجتماعية في الخطاب السياسي والموقف الرسمي، وأن على السياسي التقيُّد بها ومراعاتها في تصريحاته ونقاشاته. وهذا ما يُشكِّل الفرق ما بين السياسي والباحث العلمي، فالباحث يستطيع أن ينشر بحثه حتى وإن خالف المعتقدات الدينية أو الإتفاقيات السياسية أو ثقافة وتركيبة المجتمع الذي يعيش فيه، رغم أن لهذا ثمن قد يدفعه الباحث، ولكنه في النهاية يبقى إنتاجه العلمي الذي يُناقش علميًا وقراره الشخصي في النشر، وهو وحده يتحمل مسؤوليتة وليس الجهات الرسمية. مما لا شك فيه أن التصريح السياسي يُقرأ من زوايا عدة، سواء أكان داخليًا أم خارجيًا، وأن كل جهة تنظر للتصريح السياسي من زاوية مصالحها وأهدافها وثقافاتها، ولهذا حاولت في هذا البحث مراعاة كل هذه الأبعاد في تحديد ما يقوله وما لا يقوله السياسي الفلسطيني، مع التأكيد على أهمية السياق والمضمون للمعلومات التاريخية في الخطابات والتصريحات السياسية الرسمية الفلسطينية. تجربة الحركة الصهيونية ودولة الإحتلال 1- الاستفادة من ظهور البروتستانتية: رغم أن الخرافات والأساطير هي الجوهر الأيديولوجي للحركة الصهيونية، إلا أن هذه الحركة العنصرية استطاعت العمل بشكل منظم ومدروس على ترويج أكاذيبها وأهدافها ونجحت إلى حد كبير في تقديمها كحقائق تاريخية وإرادة ربانية. لكن هذا النجاح ليس معجزة أو قدرات خارقة للحركة الصهيونية، وإنما هو استفادة مما أنتجته إصلاحات الكنيسة ابتداءً من القرن الرابع عشر الميلادي على يد عدة إصلاحيين نادوا بإصلاح الكنيسة، كان أولهم جون ويكليف في إنجلترا (Wilson, 1884, p. 18)، وهو الذي يوصف بأنه "نجم صُبح الإصلاح" (هيل، 2003، صفحة 177) ثم ظهر بعد ذلك إصلاحيون عديدون أهمهم جون هَس (Schaff, 1915, p. 19)، ومارتن لوثر (الخضري، المصلح مارتن لوثر حياته وتعاليمه: بحث تاريخي عقائدي لاهوتي، ب س ن، صفحة 11) ثم جون كالفين (الخضري، جون كلفن: دراسة تاريخية عقائدية، 1989، صفحة 14) وهو الأكثر تأثيرًا في مفاهيم الكنيسة الأنجليكانية (هيل، 2003، صفحة 215)، وفي المهاجرين إلى أمريكا المعروفين باسم (البيوريتانيين) (Hulse, 2000, p. 12)(Puritans) والمنبثقين عن البروتستانية (مرقص، 2001، صفحة 5). حيث أدت تلك الحركة الإصلاحية إلى خلق بيئة دينية ثقافية حاضنة للروايات التوراتية في أوروبا واميريكا وخاصة المتعلقة منها بشعب الله المختار وارتباط اليهود عرقيا بسلالة يعقوب وصولا إلى سام بن نوح (السامية)، وبالتالي وجوب عودتهم إلى فلسطين. ونتيجة لهذه البيئة الثقافية التي سبقت تأسيس الحركة الصهيونية ظهر العديد من السياسيين الأوروبيين الذين وظفوا هذه الثقافة والمعتقدات الدينية المسيحية لصالح مشاريعهم الاستعمارية وحاولوا تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين، وكان أبرزهم في فرنسا نابليون بونابارت (Napoleon Bonaparte)، وفي بريطانيا الكولونيل جورج غاولر (George Gawler) (المسيري، 1982، صفحة 106)، وبهذا نجد أن الجهود الصهيونية في العمل على تهجير اليهود إلى فلسطين، ما هي إلا استكمالٌ لجهود سابقة كانت تنادي بهجرة اليهود الى فلسطين. 2- الانخراط في مصالح الدول الإستعمارية: انخرطت الحركة الصهيونية بمشاريع الدول الكبرى الرامية للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط بريطانيا أولا ثم أمِريكا، فبعد المؤتمر التأسيسي للحركة الصهونية عام 1897م برئاسة تيودور هرتزل (Landman, 1915, p. 8). استمرت هذه البيئة الدينية الحاضنة للفكر الصهيوني واستمر التوظيف السياسي لها من طرف بعض القوى الاستعمارية، فكان وعد بلفور عام 1917م (Lumer, 1973, p. 12). وما نشاهده اليوم من دعم لدولة الاحتلال الصهيوني من طرف الصهيونية المسيحية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ما هو إلا امتداد لتلك الإصلاحات التي أنتجت البروتستانتية واستمرار التوظيف السياسي لها، فالإنجيليين (evangelicals) ما زالوا يعتقدون أن تجمع اليهود في فلسطين يسرِّع بالمجيء الثاني للمسيح (spector, 2009, p. 111). 3- الاتفاق على سردية رسمية موحدة: يبدوا أن زعماء الحركة الصهيونية ادركوا منذ البداية أن التناقض والتردد يؤدي الى الشك والتشكيك، وأن الثبات على رواية واحدة مقبولة من طرف المؤمنين بالعهد القديم وتكرارها يؤدي الى قبولها وانتشارها رغم زيفها. وبعد قيام دولة الاحتلال استمرت على نفس النهج وتكرار نفس المزاعم والأكاذيب، وهذا يظهر جليًا أهمية الرؤية الواحدة لقيادة المؤسسة الرسمية والمواقف الموحدة للسياسيين والدبلوماسيين في المؤسسة الواحدة. فرغم أن أهم قادة الحركة الصهيونية وعلى رأسهم هرتزل و وايزمان لم يكونوا متدينين (المسيري، 1982، صفحة 167) إلا أنهم اتفقوا على على توظيف النصوص والروايات التوراتية؛ لتحقيق أغراضهم السياسية، ولهذا وقع الاختيار على فلسطين دون غيرها؛ لتكون وجهة الهجرات اليهودية وإقامة وطن لهم فيها (Herzl, 1896, p. 28)، مع اختلاق حلقة وصل عرقية ما بين اليهود في مختلف أنحاء العالم تتمثل بترويج فكرة طرد اليهود من فلسطين على يد الرومان قبل ثمانية عشر قرنًا من تأسيس الحركة الصهيونية (Herzl, 1896, p. 28)، كما استطاعت دولة الاحتلال أن تبلور رواية رسمية واحدة موحدة مكتملة رغم التناقض الواضح في النصوص التوراتية ورغم تناقض روايتها مع المعطيات التاريخية والآثارية، فنجد في الموقع الرسمي لوزاراة الخارجية لدولة الاحتلال ربطًا لأهم محاور الروايات التوراتية بتاريخ واحد محدد لكل محور من محاور تلك الروايات وكأنها أحداث تاريخية حقيقية (Affairs, Timeline of Historical Hilights , 2010). ومن الأمثلة على ثبات دولة الاحتلال على سردية واحدة من بين المتناقضات، أنه بالإستناد إلى أحد النصوص التوراتية (الملوك الأول: 6: 1) لتحديد تاريخ الخروج من مصر يكون الخروج عام 1450 ق.م. (Geraty, 2015, p. 56) وبالاستناد إلى نص توراتي آخر (القضاة: 11: 25،26)، يكون الخروج عام 1440 ق.م. بعد إضافة 40 عامًا من التيه، لكن بالإستناد إلى نص توراتي ثالث (الخروج: 1: 11) يكون الخروج في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وأمام هذا التناقض نجد وزارة خارجية الاحتلال تتبنى تاريخًا واحدًا وهو حوالي 1300 ق.م. (Affairs, 2010, p. 9) أهمية الفهم الرسمي الموحَّد لتاريخ فلسطين من واجبنا أن نتساءل: أين نحن -قيادة ومؤسسات أكاديمية وشعب- من هذا العمل المنظم الذي انتهجته الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال؟، وفي ظل نجاح الحركة الصهيونية بترويج الأكاذيب والخرافات، ألا نستطيع نشر الحقائق العلمية وترويجها؟ وإذا كان هناك خلاف بين المؤرخين وهواة التأريخ والمأجورين الذين يتعمدون التضليل، ألا نستطيع الدفاع عن تاريخنا وعن قضيتنا العادلة من خلال الخروج بقراءة علمية واحدة موحدة مكتملة لتاريخ فلسطين ويتم اعتمادها على الأقل من طرف القيادة السياسية وكافة السياسيين والدبلوماسيين الفلسطينيين؟ يوجد الكثير من المفاهيم الخاطئة الشائعة في ثقافة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، بل وعلى مستوى العالم ككل، وذلك بسبب التأثر بالروايات الدينية والخلط ما بينها وبين الحقائق التاريخية، ويضاف إلى ذلك بالنسبة للعرب والمسلمين التأثر بتوظيف الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال للروايات التوراتية في اختلاق مبررات دينية وتاريخية؛ لاحتلال فلسطين. وهذا ما جعل الصورة ضبابية لدى الكثيرين رغم كثرة الأبحاث والدراسات المتعلقة بتاريخ فلسطين القديم وبظهور الديانة اليهودية، وهذا ما أدى أيضًا إلى تشوه ثقافي وتناقض خطير يتمثل بالجمع ما بين الرفض والعداء لبعض الروايات التوراتية وبين القبول والايمان ببعضها والاعتقاد أنها حقائق تاريخية. ورغم ذلك نستطيع أن نصل إلى فهم رسم موحد لتاريخ فلسطين، ولدينا قراءة علمية لتاريخ فلسطين أجمع عليها كبار المؤرخين والآثاريين على مستوى العالم، ونستطيع تقديمها للعالم بكل ثقة وجرأة لأنها علمية محايدة وتنقض المزاعم الصهيونية وتنصف قضيتنا العادلة. ولهذا أقدم في هذه الورقة المادة التاريخية العلمية المبسَّطة اللازمة لكل سياسي ودبلوماسي فلسطيني، وهي مادة تقدم صورة مكتملة لتاريخ فلسطين علمية الإطار والمضمون وبلغة بسيطة تناسب غير المختصين بالتاريخ والآثار وتنقض مرتكزات الفكر الصهيوني الخرافي مثل السامية والرابط العرقي ونجمة داود، وأيضا توضح كيف كان ظهور الديانة اليهودية في فلسطين تطورا في نظام الحكم وفي مفهوم الإله وأنه تطورًا محليًا أنتجه السكان الأصليين متعددي الأعراق وليس طارءًا دخيلا جاء من العراق (إبراهيم) ولا غزوا جاء من مصر (يوشع بن نون). وهنا لا بد من الإجابة على السؤال التالي: كيف يستطيع السياسي الفلسطيني الاستفادة من الحقائق التاريخية في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية دون الوقوع في المحاذير الدينية والإجتماعية والسياسية؟ رغم أن الحقائق التاريخية المستندة لعلم الآثار تخدم عدالة القضية الفلسطينية وتنقض المزاعم الصهيونية إلا أن تقديمها لعامة الناس بكل شفافية من طرف الباحثين المختصين بالتاريخ والآثار ليس بالأمر السهل، وذلك بسبب وجود بعض التناقضات ما بين الحقائق التاريخية والمعتقدات الدينية للديانات السماوية، خاصة وأن الشعب الفلسطيني يضم مسلمين ومسيحيين وسامريين، وإذا كانت ليست سهلة على الباحث فهي خطيره إذا صدرت عن السياسي كموقف رسمي، حيث يُضاف إلى اعتبارت الباحث مسؤولية السياسي والجهات الرسمية في الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي واحترام المعتقدات الدينية وضمان حرية المعتقد والعبادة، وهذا يستوجد من السياسي الفلسطيني التالي: أولًا: معرفة الحقبات التاريخية وأهم أحداث التاريخ القديم غالبًا ليس لدى الدارس للعلوم السياسية مشكلة في فهم التاريخ الوسيط والحديث والمعاصر، وإنما في فهم حقبات وإشكاليات التاريخ القديم، ولهذا تعتبر معرفة الحقبات التاريخية قاعدة أساسية لتنظيم المعلومات ووضعها في سياقها التاريخي، فهذا الفهم العام في ذاكرة القارئ للتاريخ هو بمثابة رفوف المكتبة المرتبة بشكل تسلسلي بحيث يضم كل رف حقبة تاريخية معية، وعندما يقرأ السياسي أو يسمع معلومات تاريخية يضعها مكانها وسياقها التاريخي الصحيح. ولضمان أن يكون فهم التاريخ سهلا بالنسبة للسياسي يجب عدم الخوض في التفاصيل وخاصة تلك التي تسبق الفترات الزمنية التي تهم السياسي، مثل الخلاف حول تأريخ نهاية العصر الحجري النحاسي مثلًا، وإنما يكفي السياسي بأن يعرف أن العصر الحجري النحاسي يمتد من 4500 ق.م إلى 3500 ق.م (Bar, 2014, p. 44)، وأن ما قبل ذلك هو العصور الحجرية وما بعده العصور البرونزية والتي تمتد لغاية العام 1200 ق.م. (Grabbe, 2016, p. 173) حيث ينتهي العصر البرونزي المتأخر ويبدأ العصر الحديدي. وعند الحديث خرافات وروايات التوراة يجب أن يعرف السياسي بأنها مرفوضة تاريخيًا وآثاريًا، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يعرف الزمن المفترض الذي تروجه دولة الاحتلال ومن يؤمنون بصحتها، فالزمن المفترض لخروج بني إسرائيل من مصر هو القرن الثالث عشر قبل الميلاد والزمن المُفترض لمُلك داود وسليمان هو القرن العاشر قبل الميلاد (Affairs, 2010, pp. 9,10). أما السبي البابلي فيبدأ عام 586 ق.م. وينتهي بسيطرة الفرس على فلسطين عام 538 ق.م، (Dever, 2005, pp. 291,293)، وبعد خضوع فلسطين لليونان عام 332 ق.م. (Magness, 2012, p. 53) ثار اليهود ضدهم عام 167 ق.م. وهي الثورة المعروفة باسم الثورة المكابية والتي انتهت بالاستقلال ونجاح الأسرة الحشمونية في حكم فلسطين (Meyers & Chancey, 2012, p. 26). وفي عام 63 ق.م أصبحت فلسطين تحت سيطرة الرومان (Magness, 2012, p. 93) وقد شهدت هذه الفترة حكم فلسطين باسم روما من طرف الملك هيرود خلال السنوات 37 ق.م الى 4 ق.م. (Richardson & Fisher, 2018, p. 127. 209)، وشهدت أيضا ثورتين تمكن الرومان من إخمادهما، الأولى عام 66 م. (Mason, 2016, p. 202) والثانية عام 132 م والمعروفة باسم ثورة باركوخبا (Mor, 2016, p. 145) . ثم الفترة البيزنطية التي تعتبر امتدادًا للفترة الرومانية، لكن الفرق هو الاعتراف بالديانة المسيحية كإحدى الديانات القائمة في الإمبراطورية وبناء القسطنطينية كعاصمة للإمبراطورية البيزنطية -القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية بعد انقسامها- وذلك عام 330 م. (عوض، 2007، صفحة 127،129)، أما الفتوحات الإسلامية فكانت عام 637 م. (Kennedy, 2007, p. 91). ثانيًا: فهم الإطار العام لتاريخ فلسطين القديم يعدّ فهم الإطار العام لتاريخ فلسطين مادة مهمة ومفتاح النجاح في الخطاب السياسي، فهو يساعد على إيصال الرسالة السياسية التي تتضمن معلومات تاريخية هادفة بلغة علمية بسيطة، وأهم محاور الفهم العام لتاريخ فلسطين القديم هو: - المعرفة بأن كل ما شهدته فلسطين القديمة من حضارات منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا، هو نتاج التطور المحلي للسكان الأصلين الذين اختلطوا بعدة شعوب وتأثروا بعدة حضارات، وبالتالي فإن كل ما على أرض فلسطين من موروث ثقاقي سواءً كان ملموسًا أو غير ملموس هو ملك للشعب الفلسطيني. - التمييز ما بين الحركة الصهيونية والديانة اليهودية، وبالتالي التمييز ما بين السكان الأصليين الذين اعتنقوا الديانات الوثنية ثم السماوية بما فيها اليهودية وبين الهجرات اليهودية التي نظمتها الحركة الصهيونية لليهود من مختلِف أنحاء العالم مع إختلاق رابط عرقي زائف يربطهم بفلسطين عرقيًا. فالشعب الفلسطيني على مر العصور هو الشعب الوثني الذي اعتنق الديانة اليهودية والموسوية –السامريين- ثم المسيحية والإسلام. أما اليهود الذين جلبتهم الحركة الصهيونية من مختلف أنحاء العالم، فلا يربطهم بفلسطين أي رابط عرقي أو تاريخي وإنما هو رابط ديني فقط، لأن الديانة اليهودية انتشرت في فلسطين وخارجها دون ضوابط عرقية، ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك اعتنقاق الديانة اليهودية من طرف مملكتي حِمْيَر والخزر. ثالثًا: التمييز ما بين الروايات التوراتية والرواية الصهيونية يُفضَّل أن يكون تركيز السياسي في تصريحاته ونقاشاته على الرواية الصهيونية وليس الروايات التوراتية، وإذا وجد أنه مجبر على نقاش التفاصيل المتعلقة بتاريخ فلسطين القديم والروايات الدينية يقدم الحقائق العلمية بصفة المحايد الذي ينقل المعلومة وينسبها لمصدرها العلمي. قد تبدو هذه الإجابة للبعض أنها غامضة أو نظرية وغير قابلة للتطبيق، وقد يتساءل البعض: كيف نميز ما بين الرواية الصهيونية والروايات التوراتية إذا كانت الحركة الصهيونية نسجت روايتها من التوراة؟ في الحقيقة يستطيع السياسي الفلسطيني التمييز بسهولة ما بين الرواية الصهيونية والروايات التوراتية، ويستطيع أن ينقض الرواية الصهيونية دون الحديث عن الروايات التوراتية، وإذا استوجب الأمر الخوض بتفاصيل تتضمن تناقضا ما بين الحقائق التاريخية والمعتقدات الدينية يستطيع أن يعرض الحقائق التاريخية بحياد وبإسنادها إلى مصادرها دون تبنيها، ويترك الأمر للمستمع ليفكر ويبحث. لكن حتى يصل السياسي الفلسطيني لهذه المرحلة ليس مطلوب منه أن يكون مؤرخًا أو آثاريًا وإنما أن يمتلك الحد الأدنى من المادة العلمية اللازمة التي تمكنه من فهم الإطار العام لتاريخ فلسطين القديم، التمييز ما بين الرواية الصهيونية والروايات التوراتية، التمييز ما بين الحقائق التاريخية والروايات الدينية. ويكون ذلك على النحو التالي: - ما نسميه بالمفهوم الإسلامي التوراة والروايات التوراتية هي العهد القديم من الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين، أي انها جزء من الايمان المسيحي، ويؤمن السامريون بأسفارها الخمسة الأولى، كما أن الكثير من تلك الروايات مكررة في القرآن الكريم وفي كتب التفسير. - يقدم علم التاريخ والآثار حقائق تتناقض مع الكثير من تلك الروايات والنصوص الدينية. - تبنت الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال الروايات التوراتية ووظفتها كمبررات دينية وتاريخية تعطي نوعًا من الشرعية لاحتلال فلسطين. - لا تعني تلك الروايات شيء بالنسبة للحركة الصهيونية ودولة الاحتلال دون اختلاق رابط عرقي يربط جميع اليهود في مختلف أنحاء العالم بتلك الروايات وبالتالي بفلسطين، لأن الرابط الديني لا يعني بالنسبة لليهود أكثر من الحق بالسياحة الدينية، أما إختلاق رابط عرقي وخروج قسري على يد الرومان يسهل عملية إقناع اليهود وتجييشهم للهجرة الى فلسطين واحتلالها. - يعتير اختلاق الرابط العرقي ليهود العالم بفلسطين هو الركيزة الأساسية للرواية الصهيونية، وبالتالي فإن قيام السياسي الفلسطيني بنقض الرابط العرقي وتفسير وجود اليهود في مختلف أنحاء العالم نسفًا للرواية الصهيونية دون الخوض بالمعتقدات الدينية. - يجب يركز السياسي الفلسطيني الحقائق التاريخية التي تقول بأن التوراة وظهور الديانة اليهودية هي جزء من تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني، فعبر مراحل تطور مفهوم الإله وقبل ظهور الديانات السماوية كان أجدادنا وثنيين، وقبل الفتوحات الإسلامية كانوا يهود وسامريين ومسيحيين ثم اعتنق الغالبية الإسلام، وكل معبد أو كنيس أو كنيسة مهما كان تاريخها صلى فيها أجدادنا في السابق. رابعًا: النقض المباشر للرواية الصهيونية غير المرتبطة بالمعتقدات الدينية يعدّ الرابط العرقي المُفترض الذي يربط يهود العالم بفلسطين هو الركيزة الأساسية للرواية الصهيونية، لكن يستطيع السياسي الفلسطيني أن يقول بثقة إن الرومان لم ينفوا سكان فلسطين وإنه لا يوجد رابط عرقي يربط يهود العالم بلفلسطين، وإن الديانة اليهودية انتشرت في مختلف أنحاء العالم كأي ديانة أخرى دون أن تكون محصورة بعرق معين، وإن اعتناق مملكتي حِمْيَر والخزر للديانة اليهودية هو دليل تاريخي دامغ يفسر انتشار الديانة اليهودية خارج فلسطين وينفي الرابط العرقي. وبهذا يكون السياسي الفلسطيني قد نفى بلغة علمية بسيطة هذا الرابط دون الخوض بالروايات التوراتية، لكن هذا يستوجب معرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع المحوري في الرواية الصهيونية، ويكون على النحو التالي: 1- قامت الحركة الصهيونية باختلاق رابط عرقي هدفه انخراط اليهود في مختلف أنحاء العالم في مشروعها الاحتلالي العنصري، مستندةً إلى الاعتقاد السائد بأن وجود اليهود في أوروبا هو نتيجة لنفي الرومان لهم وتهجيرهم من فلسطين عام 70م. والذي مصدره المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسيفوس -Flavius Josephus-، وهو يوسف بن ماتيتياهو -Joseph ben Matityahu-، لكن من خلال ولائه وعمله مترجمًا ووسيطًا لدى فاسبيزيان (Vespasian) وابنه تايتوس –Titus- في أثناء حصارهم للقدس، استطاع يوسيفوس كسب صداقة فاسبيزيان -الذي أصبح امبراطورًا، وعندما أصبح يوسيفوس مواطناً رومانياً حمل اسم عائلة فلافيوس –اسرة فاسبيزيان- بدل ماتيتياهو، وعاش في روما إلى أن توفي عام 100 م. (Sorek, 2008, pp. 18,19)، وفي روما كتب مؤلفاته التاريخية (Rajak, 2003, p. 1)، التي تتسم بالتناقض والتفاخر والمبالغة والكذب (Seward, 2009, p. 272). لكن ما ذكره يوسيفوس حول نفي الرومان لليهودِ من فلسطين، لم يَعُد مقبولاً من الناحية التاريخية، فالرومان سيطروا على فلسطين عام 63 قبل الميلاد (Bunson, 2002, p. 22)، وعندما ثار اليهود على حكمهم خلال السنوات 66-70 م (Goodman, 1987, p. 1)، انتهت الثورة بإخمادها من طرف الرومان وتدمير أسوار القدس وحرق الهيكل )المعبد( فيها (العارف، 1951، صفحة 35). لكن لم يقوم الرومان يوماً بنفي وتهجير شعب كامل من أرضه، ولم يَرِد في مصادر الرومان ما يشير إلى حدوث هذا السبي، وقوس تايتوس -Arch of Titus- يُصوِّر عودة الجنود الرومان بعد تدمير معبد القدس ويحملون معهم الأسلاب ومنها الشمعدان. وليس اليهود المسبيين وهم في طريقهم إلى المنفى (Sand, 2009, pp. 130,131). كما أن اندلاع ثورتة اليهود ضد الرومان عام 132 م والتي استمرت إلى العام 135/136 م وعرفت باسم ثورة باركوخبا (Magness, 2012, p. 258)، والتي قمعها الرومان أيضاً دون نفي اليهود (Sand, 2009, pp. 132,133) دليل على وجود اليهود وعدم نفيهم عام 70 م. صورة اللوحة المنحوتة على جدار قوس تيتوس والتي تُصوِّر موكب النصر للرومان في أثناء عودتهم من القدس ومعهم الأسلاب (Fine, 2016) وحين نتحدث عن معتنقي الديانة اليهودية سواء داخل فلسطين أو خارجها، فنحن نتحدث عن عدة أعراق اعتنقت الديانة اليهودية، فسكان فلسطين وهي مهد الديانة اليهودية متعددي الأعراق، خلال الثورة المكابية ضد اليونان في القرن الثاني قبل الميلاد نجد أن انتشار الديانة اليهودية في فلسطين كان بالقوة ودون أي اعتبار عرقي، حيث خيَّر جون هيركانوس (134-104 ق.م.) السكان ما بين اعتناق الديانة اليهودية والترحيل (Magness, 2012, p. 95). وأيضًا كان انتشار الديانة اليهودية في مختلف أنحاء العالم دون ضوابط عرقية، وأهم ما يثبت ذلك هو اعتناق الديانة اليهودية من طرف مملكتين لا تنتميان إلى فلسطين عرقيًّا، وهما مملكتا حِمْيَر والخزر. فمملكة حِمْيَرْ كانت وثنية الديانة كبقية ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية، اعتنقت الديانة اليهودية حوالي عام 384 م، وانتهت عام 525 م على يد بيزنطة وملك الحبشة وأصبحت اليمن تحت حُكم الحبشة (Maroney, 2010, p. 16). أما مملكة الخَزَرْ فهي من قبائل الأتراك الرُّحَّل (Dolukhanov, 2013, p. 172)، وقد اعتنقت الديانة اليهودية خلال النصف الأول من القرن 9 م. (Brook, 2006, p. 94). إلى أن دُمِّرت تلك المملكة في حوالَي 965 – 969 م (Golden., 2007, p. 7) على يد روس كييف أو خقانات روس (Curta, 2008, p. 351). خامسًا: الحديث بلغة حيادية عند تفنيد الرواية الصهيونية المقتبسة من النصوص التوراتية تستند الرواية الصهيونية في بعض مضمونها على إقتباسات توراتية، هي في الحقيقة جزء من الايمان المسيحي والسامري وحتى الإسلامي لكون بعض تلك الروايات ذكرت في القران الكريم او كتب التفسير. ورغم أن ما يؤمن به السياسي أو أي انسان هو أمر يخصه وحده وليس من حق أيٍّ كان أن يسأله عن مدى إيمانه بالمعتقدات الدينية، وأنه إذا سُئِل من حقه أن يجيب بأن ايمانه أمر شخصي يخصه وحده، إلا أن نقض هذا الجزء من الرواية الصهيونية المرتبط بالمعتقدات الدينية يستوجب الحذر الشديد من طرف السياسي الفلسطيني، لأن السياسي في منصب رسمي يمثل موقفًا رسميًا وليس رأيًا شخصيًا. ونظرًا لأهمية نقض تلك الروايات والمزاعم في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية -رغم تناقض الحقائق التاريخية مع المعتقدات الدينية-، أعتقد أنه من الضروري معرفة السياسي الفلسطيني بالحقائق التاريخية التي تنقض تلك الروايات ولكن أن يقدمها بلغة المحايد الذي ينقل الحقائق دون إعلان التبني لها، فيقول بحسب علم التاريخ والآثار ويترك للمستمع التفكير والبحث، وذلك على النحو التالي: 1- خرافة السامية وتوظيفها صهيونيًّا من الأمثلة على اقتباس الحركة الصهيونية نصوصًا وروايات من التوراة وتوظيفها سياسيًا هو خرافة السامية التي تعتبر من أكثر الخرافات شيوعًا على مستوى العالم، وسبب هذا الانتشار والتداول لمصطلح السامية بمدلولاته العرقية واللغوية، أنها وردت في التوراة التي تُعد أكثر الكتب انتشارًا وتداولا حول العالم؛ نظرًا لأهميتها الدينية لدى اليهود والمسيحيين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم. ترتكز خرافة السامية العرقية على مرتكزين، أحدهما توراتي مصدره سفر التكوين، أما الآخر فهو صهيوني تمثل بتبني الحركة الصهيونية للمرتكز التوراتي والأضافة عليه وترويجه لتحقيق أهدافها السياسية العنصرية. أصل "السامية" في التوراة جاء في سفر التكوين في إطار قصة حدوث طوفان كبير قضى على كل البشر والحيوانات والطيور باستثناء نوح الذي صنع سفينة ضخمة وأخذ معه في السفينة من كل الكائنات الحيَّة فنجى ومن معه في السفينة (التكوين: 6: 9). وما يهمنا هنا هو أن من بقي من البشرية بعد هذا الطوفان -كما جاء في النَّص التوراتي- هو نوح الذي توفي لاحقًا وبقي وأبناؤه سَامًا وَحَامًا وَيَافَثَ (التكوين: 10: 1)، ومن نسلهم أصل كل البشر (التكوين: 10: 32)، وأن إِبْرَاهِيم من نسل سَامٌ بن نوح (التكوين: 11: 10-27) أما كنعان فهو ابن حام بن نوح (التكوين: 9: 18)، وأن نوح بارك سام ولعن كنعان وحكم عليه بالعبودية لسام ويافث (التكوين: 9: 25-27)، وأن الكنعانيين –سلالة كنعان- هم سكان أرض كنعان وهي الأرض التي وعد الله ابراهيم –وهو من سلالة سام- بامتلاكها (التكوين: 12: 6). وبهذا نجد أن الكنعانيين في النصوص التوراتية هم عرق ينسب لكنعان، وهذا أمر لم يَعُد مقبولا تاريخيا، فكنعان قد تعني الأرض المنخفضة أو الصباغ الأرجواني (الماجدي، 1999، صفحة 13) ولكن لا تعني اسم شخص أو جَد، ومثل هذه التسميات في وصف الشعوب كانت دارجه كما هو الحال بالنسبة للأموريون، فهو اسم أطلقه الأكاديون في العراق على سكان المناطق الواقعة إلى الغرب منهم (وهي بالتسميات الحالية: سوريا ولبنان وفلسطين وشرق نهر الأردن)، فهذه التسمية -mârê Ammurrum- تعني أبناء الأرض الغربية (Buck. , 2020, p. 15) وليس اسم جَد. - التوظيف الصهيوني لخرافة السامية العرقية بالاستناد إلى التقسيم التوراتي الخرافي للأصول العرقية لشعوب العالم، وأن اليهود ساميين (من نسل سام بن نوح)، يكون اليهود هم العرق السامي في أوروبا وَفقاً للتقسيمات التوراتية، ومعاداتهم تعني معاداة العِرق السامي. وعلى قاعدة هذا التقسيم التوراتي ظهر مصطلح اللاسامية في اوروبا قبل إعلان تأسيس الحركة الصهيونية، والذي يعني معاداة السامية -Anti-Semitism-، وهو مصطلح ابتكره عالم اللاهوت النمساوي أوغست شلوزر -August Schloetzer- عام 1771م (Holub., 2016, p. 126) ثم الصحافي الألماني ويلهلم مار -Wilhelm Marr- عام 1879م بعد ذلك أخذ المصطلح دلالة سياسية عام 1860م على يد يهودي من بوهيميا واسمه موريس شنايدر -Moritz Steinschneider- (كاظم، 2017، صفحة 262). وبعد إنشاء الحركة الصهيونية، قامت هذه الحركة العنصرية بتبني هذا التقسيم العرقي التوراتي وترويجه ورغم أن هذا الرابط العرقي مجرد خرافة إلا أن الحركة الصهيونية استطاعت من خلال مصطلح اللاسامية أن تلعب دور ضحية العنصرية العرقية، وتعتبر أي نقد يوجه لها أو لليهود -بصفتهم أفرادًا أو جماعات- أنه عنصرية عرقية. - نقض خرافة السامية العرقية بحسب الرواية التوراتية فقد خلق الرب الكون وآدم في ستة أيام (التكوين: 2: 1، 2، 7). وبناءً على تحديد النصوص التوراتية لأعمار السلالة البشرية ابتداءًا من آدم، فقد ظهر ما يُعرف بالتقويم العبري (Hebrew chronology) والذي يقوم على حساب عمر السلالة البشرية ابتداءًا من آدم بناءً على عمر كل أب عندما أنجب الإبن الذي يليه في هذه السلالة، مثلًا: عندما كان عمر آدم 130 عامًا أنجب شِيث وعاش آدم بعد أن أنجب شِيث 800 عامًا، فكان مجموع ما عاشه آدم 930 عامًا، وعندما كان عمر شِيث 105 أعوام أنجب أَنُوش، وعاش بعد أن أنجب أَنُوش 807 أعوام، فكان مجموع ما عاشه شِيث 912 عامًا (التكوين: 5: 1-11). وبطريقة التقويم العبري يتم جمع 130 -وهو عمر آدم عندما أنجب شِيث- إلى 105 –وهو عمر شِيث عندما أنجب أَنُوش- ... ألخ. وبحسب هذا التقويم يكون نوح قد ولد بعد 1657 عامًا من خلق آدم، بينما ولد ابراهيم بعد 1948 من خلق آدم (Hughes, 1990, p. 12). أما بداية الخَلق فتعود إلى عام 3760 قبل الميلاد (الوردات، 2013، صفحة 103)، أو 4004 قبل الميلاد بحسب التسلسل الزمني الذي أعدَّه جيمس آشر -James Ussher- عام 1650 ميلادي (Lewis & Knell, 2001, p. 109). لم يعد مقبولًا علميًا إرجاع بداية الخلق إلى العام 3760 أو العام 4004 قبل الميلاد، وذلك للأسباب التالية: - منذ الحرب العالمية الثانية ظهرت تقنيات تأريخ جديدة وهي التأريخ الإشعاعي -Radiometric dating- التي أتاحت تأريخ الأحداث بدقة، ليس فقط تاريخ البشرية قبل ظهور الكتابة وإنما ايضًا تأريخ تشكُّل الكون قبل ظهور البشرية على سطح الأرض، وهو ما يُعرف بالإنفجار العظيم -Big Bang- قبل 13.7 مليار سنة (Christian, 2008, pp. 1,3). - من خلال المستحاثات –fossils- أرجَع العلماء بداية التطور الذي أنتج لاحقًا الانسان إلى سبعة ملايين سنة، أما بداية ظهور الإنسان الماهر هومو هابيلاس -Homo Habilis- فتعود لحوالي مليونين سنة، وهي بداية استخدام الإنسان يديه في صنع أدوات حجرية بسيطة، ولهذا يطلق عليه -handy man- حيث ظهرت أدوات حجرية بدائية مبكِّرة بالتزامن مع هذا الإنسان (Roberts, 2011, pp. 58, 98, 100). ومن خلال المكتشافات في عدة مواقع في مختلف أنحاء العالم، فقد تبيَّن استمرار تطور الإنسان من حيث شكله وهيكله العظمي ومهاراته وأدواته، وأيضًا حجم أسنانه وشكلها والتي كانت أقرب لأسنان القرد، بالإضافة إلى شكل جمجمته وحجم دماغه –وهو الأهم في إحداث التطور- الذي كان في البداية صغيرًا وأقرب لحجم دماغ القرد منه للإنسان، ولا ننسى في سياق هذا التطور أهمية القدرة على النطق في ظهور اللغة وبالتالي التواصل وتبادل وتوريث الخبرات. ورغم وجود الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع لكن لا يهمنا منها في هذا البحث سوى الإطار العام لهذا التطور وتسلسه الزمني، وذلك نظرًا لأهمية تأريخ ظهور الإنسان وكيفية ظهوره، للمقارنة مع المعتقد والوصف التوراتي حول خلق آدم وتصنيف العالم نسبة لأبناء نوح، ومنهم الساميون نسبة لسام بن نوح. صُنِّفَ ذلك التطور إلى عدة مراحل، أبرزها: الإنسان المنتصب هومو إرِكْتاس -Homo erectus- قبل نحو 1.7 مليون عام (Wood, 2005, p. 87)، ثم ظهر هومو هايدلبيرغينيسيس -Homo heidelbergensis- الذي عاش قبل فترة تمتد من 500 ألف إلى 400 ألف عام (Coolidge & Wynn, 2009, p. 208)، على امتداد مساحات واسعة من جنوب إفريقيا إلى شمال أوروبا، واتصف هذا الإنسان بحجم دماغ كبير وعضلات قوية وقدرة على صيد الحيوانات الكبيرة وصناعة أدوات حجرية دقيقة نسبيًا، وهذا الإنسان هو السَّلَف للإنسان البدائي المعروف باسم نيانِدرتال -Neanderthal- (Roberts, 2011, pp. 34 , 36) الذي عاش في أوروبا قبل نحو 400 ألف عام (Gagnepain & Gaillard, 2006, p. 43)، وهو أيضًا السَّلف للإنسان العاقل هومو سيبيانز -Homo sapiens- (Coolidge & Wynn, 2009, p. 208) الذي عاش في إفريقيا قبل نحو 200 ألف عام (Rutherford, 2018, p. 3) وانتشر في غرب آسيا قبل حوالي 100 ألف عام (Coolidge & Wynn, 2009, p. 210) وفي أوروبا لاحقًا قبل نحو 40 ألف عام (Roberts, 2011, p. 166). أصبح واضحًا أن الوصف التوراتي لبداية خلق الكون والإنسان بعيدة كليًا عن الحقائق العلمية والتاريخية، وأن الوصف التوراتي للطوفان وقصة نوح التي انبثقت عنها السامية هي مجرد خرافة، لأن من كتبوا قصة نوح في سفر التكوين كانوا قد اقتبسوها عن ملحمة كَلكَامش أو جَلجَامِش الشِّعرية -The Epic of Gilgamesh-، والتي تعود للثلث الأخير من الألفية الثالثة قبل الميلاد، وغالبًا في زمن سرجون الأول الأكَّدي (2325- 2269 ق.م.) (الأحمد، 1984، صفحة 14)، مع تجسيد أوتونابيشتيم في ملحمة كَلكَامش في شخصية نوح في سفر التكوين. وبهذا نجد أن إرجاع التوراة خلق الكون وخلق آدم إلى العام 3760 أو العام 4004 قبل الميلاد هو زمن متأخر جدًا ويتناقض تمامًا مع المعطيات العلمية، كما أن فكرة الطوفان وما ترتب عليها من تصنيف عرقي للبشرية، هي خرافة اقتبسها الذين كتبوها في التوراة من ملحمة جَلجَامِش في بلاد ما بين النهرين. وفي إطار توظيف الحركة الصهيونية لروايات العهد القديم من الكتاب المقدس سياسيًا، استخدمت مصطلح "السامية" لتمييز اليهود عرقيًا عن محيطهم ووسْم أي نقد أو معارضة لأي يهودي بأنه تصرف عنصري ينطلق دوافع عرقية، على اعتبار تميُّز ذلك اليهودي بأنه "سامي" العرق يعيش بين أعراق مختلفة، ولربط اليهود في مختلف أنحاء العالم بالعرق السامي قامت باختلاق رابط عرقي مستندةً إلى ذكره يوسيفوس بأن الرومان قاموا بنفي اليهود من فلسطين عام 70 م. وهو ادعاء زائف كما بينا في إطار نقض الرابط العرقي لهيود العالم بفلسطين. وفي نفس سياق مصطلح السامية فإن خرافة اللغات السامية هي امتداد لخرافة السامية العرقية، وكلاهما يستند للنصوص التوراتية ويتماشى معها، حيث أصبح شائعًا أن جذر لغات الشرق الأدنى القديم هو جذر سامي تفرعت عنه لغات أخرى وذلك على اعتبار أن اللغة الأم هي اللغة السامية التي تفرعت عنها لغات أخرى (Weninger, 2011, p. 263). وقد استخدم مصطلح اللغات السامية لأول مره من طرف عالم اللاهوت الألماني يوهان أيكهورن -Johann Gottfried Eichhorn- عام 1777 م. (Holub., 2016, p. 126) وبعد أن بيَّنت مدى تناقض فكرة السامية العرقية مع المعطيات العلمية، أصبح نقض تسمية اللغات السامية تحصيل حاصل على اعتبار أنها تسمية خرافية بنيت على خرافة عرقية وكلاهما من مصدر ليس علميًّا. فالتوراة ليست مرجعاً تاريخياً، ومصطلح "السامية" ليس مصطلحاً علمياً من الناحية التاريخية واللغوية لتُصَنَّف بموجبه اللغات (حنون، 2011، صفحة 163). ومن ناحية أخرى فإن اللغة السومرية رغم أنها من لغات الشرق الأدنى القديم لا يربطها شيء ببقية اللغات التي تم تصنيفها كلغات سامية، فهي لغة منفردة بقواعدها ونحوها ومفرداتها ولا تشبه أي لغة حية أو ميتة (Kramer, 1963, p. 306). ورغم أن مصطلح "اللغات السامية" هو تعبير مجازي مقتبس من التوراة، إلا أنه مصطلح رمزي للغة مجهولة الاسم، وهو مصطلح شائع الاستخدام، بل ويستخدمه المختصوص في الدراسات العلمية رغم علمهم بأنه اسم رمزي مَجازي. لهذا ورغم عِلمنا ان مصطلح "اللغات السامية" تعبير مجازي مقتبس من التوراة إلا أنه لا بديل عن استخدامنا لهذا المصطلح والحقيقة أن استخدام المصطلحات والأسماء الشائعة المجازية في الدراسات العلمية، هو أمر مقبول مادام الاسم الحقيقي مجهول وما دام هذا المصطلح يحمل المفهوم المطلوب لحين توصلنا إلى بديل علمي. 2- ظهور الديانة اليهودية هو تطور محلي والتوراة هي جزء من تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني ظهور الديانة اليهودية في فلسطين هو تطور محلي وليس دخيل، فربط الديانة اليهودية بعرق دخيل قادم من العراق (إبراهيم) هو أمر لم يَعُد مقبولا من الناحية التاريخية والآثارية، لأن ظهور الديانة اليهودية كان تطوراً محليًا تدريجيًّا لمفهوم الإله وتطورًا في نظام الحكم لدى أعراق متعددة تسكن أرض كنعان يمثلون شعب فلسطين القديمة. ففي لوحة مرنبتاح التي تعود إلى عام 1208 ق.م. (Dever, 2015, p. 402) ظهرت (يسرءِار) أو (ysry3r) (Killebrew, 2005, p. 154) بصفتها قبيلة بدوية في فلسطين (Geraty, Exodus Dates and Theories , 2015, p. 58). ثم نجد في لوحة الملك ميشع المؤابي التي تعود إلى حوالَي عام 850 ق.م. (Bennett, D, & D, 1911, p. 6) أن هذا النظام القَبَلي تطور إلى نظام ملكي على رأسه ملك (هاردنج، 1965، صفحة 34)، وأن (يِسرِءار) القبيلة أصبحت مملكة وهي (Ysr’l) (يسرءَل) أو (يسرأل) (Becking, 2007, pp. 54,55). أما بالنسبة للتطور الديني فقد ظهر اسم (يهوه) بثلاثة حروف (Yhw) في القائمة الجغرافية التي في صوليب ( أبو بكر، 1985، صفحة 93)، التي تعود إلى نهاية القرن 15 ق.م.، والتي تحدثت عن بدو (عيد، 1996، صفحة 51) في مؤاب وأدوم (Redford, 1995, p. 272)، ذُكر في موقع كونتيلة عجرود -Kuntillet ‘Ajrud- (فوروهاجن، 2017، صفحة 177)، ومعه الإلَهَان إيل وبعل (السواح، 2003، صفحة 204)، والمعبودة عشيرة هي زوجته (Finkelstein & Silberman, 2001, p. 242)، "Yahweh and his Asherah" (Meshel, 2011, p. 52)، وأيضا في خربة الكوم عُثِرَ على نقش كُتب على قبر يعود تاريخه إلى القرن 8 ق.م. (Dever, 2005, p. 132) وجاء فيه "لتحل عليك بركة الإله يهوه وعشيرته" (السواح، 2003، صفحة 204). ثم ظهرت محاولتان لعبادة يهوة بصفته إلهًا أوحد، الأولى كانت خلال السنوات 705 – 701 ق. م. في عهد الملك حزقيا (Finkelstein & Silberman, 2001, p. 251) والثانية كانت خلال السنوات 640 – 609 ق.م. في عهد الملك يوشيا (Dever, 2005, p. 71). لكن هاتين المحاولتان لم تنجحا، وبقيت الآلهة عشيرة تحديدا حاضرة، وبقيت أرض كنعان وثنية خلال العصر الحديدي (Finkelstein & Silberman, 2001, p. 242). الخاتمة نسعى للتحقق من النصوص والروايات التوراتية لأهداف علمية بحته، وليس استهدافًا للكتب السماوية أو المعتقدات الدينية، وسواء أشئنا أم أبينا فإن التوراة تبقى بكل ما لها وما عليها جزءًا من الموروث الثقافي لشعبنا الفلسطيني الذي اعتنق الديانة اليهودية والموسوية (السامرية) ثم المسيحية قبل أن تتحول الغالبية لاعتناق الديانة الإسلامية بعد الفتوحات الإسلامية. يجب أن يتذكر السياسي دائمًا وأن يذكِّر من يتحدث إليهم بأنه حين يفند الروايات التوراتية فإنه يتحدث ديانة آمن بها أجداده قبل أن يصبحوا مسيحيين ومسلمين، وأنه يضع ما كتبه أجداده في السياق الديني الديني الصحيح كعبادات وشرائع ومواعظ، ويضعه أيضَا في سياقه التاريخي الصحيح كنصوص بدأ أجداده بكتابتها في القرن السابع قبل الميلاد ثم صاغوها خلال فترة السبي البابلي وما بعدها وصولًا الى القرن الثاني قبل الميلاد، وأن عداءَه ليس للروايات والنصوص التوراتية وإنما لدولة الاحتلال ولليهود الصهاينة من سلالة مملكتي حِميَر والخزر الذين اختلقوا رابطًا عرقيًا وتاريخيًا يربطهم بفلسطين وأخرجوا النصوص التوراتية من سياقها الدين واستخدموا لتنفيذ عنصريتهم وتبرير احتلال لهم لفلسطين. المراجع Bibliography Affairs, I. M. (2010). Facts About Israel. Jerusalem: Israel Ministry of Foreign Affairs. Affairs, I. M. (2010). Timeline of Historical Hilights . Retrieved 1 13, 2022, from Israel Ministry of Foreign Affairs - Facts About Israel: https://www.mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/History/Pages/Facts%20about%20Israel-%20History.aspx Bar, S. (2014). The Dawn of the Bronze Age. LEIDEN: Brill. Becking, B. (2007). From David to Gedaliah: The Book of Kings as Story and History. Fribourg: Acadimic Press Fribourg. Bennett, W. H., D, D., & D, L. (1911). The Moabite Stone. New York: Charles Scribner’s Sons. Brook, K. A. (2006). The Jews of Khazaria (2 ed.). Lanham: Rowman & Littlefield. Buck. , M. E. (2020). The Amorite Dynasty of Ugarit: The Historical Origins of the Bronze Age Polity of Ugarit Based Upon Linguistic, Literary, and Archaeological Evidence. “PhD thesis, University of Chicago, 2018”. Leiden: ocks å Brill. Bunson, M. (Ed.). (2002). Encyclopedia of the Roman Empire (Revised ed ed.). New York: Facts on File. Christian, D. (2008). Big History: The Big Bang, Life on Earth, and the Rise of Humanity. USA: The Teaching Company. Coolidge, F., & Wynn, T. (2009). The Rise of Homo Sapiens: The Evolution Of Modern Thinking. Chichester: Wiley – Blackwell. Curta, F. (2008). The Other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars and Cuman. Leiden: Brill. Dever, W. G. (2005). Did God Have a Wife? : Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. Dever, W. G. (2015). The Exodus and the Bible: What Was Known; What Was Remember; What Was Forgotten? In T. E. Levy, Israel’s Exodus in Transdisciplinary Perspective: Text, Archaeology, Culture, and Geography (pp. 399-408). New York: Spriger. Dolukhanov, P. M. (2013). The Early Slavs: Eastern Europe from Initial Settlement to the Kievan Rus. London: Routledge Taylor & Francis Group. Fine, S. (2016, 9 29). 7 facts about menorahs, the most enduring symbol of the Jewish people. Retrieved 1 26, 2022, from The Times Of Israel: https://www.timesofisrael.com/7-facts-about-menorahs-the-most-enduring-symbol-of-the-jewish-people/ Finkelstein, I., & Silberman, N. A. (2001). The Bible Unearthed. New York: simon and schuster. Gagnepain, J., & Gaillard, C. (2006). Neanderthal Occupation in the Verdon Vally (Haut-Provence, Southeastern France). In N. J. Conard, & J. Richter, Neanderthal Lifeways, Subsistence and Technolog: One Hundred Fifty Years of Neanderthal Study (pp. 43-51). Geraty, L. T. (2015). Exodus Dates and Theories . In T. E. Levy, Israel’s Exodus in Transdisciplinary Perspective: Text, Archaeology, Culture, and Geography (pp. 55-64). New York: Spriger. Geraty, L. T. (2015). Exodus Dates and Theories. In T. E. Levy, Israel’s Exodus in Transdisciplinary Perspective: Text, Archaeology, Culture, and Geography (pp. 55-64). New York: Spriger. Golden., P. B. (2007). Khazar Studies: Achievements and Perspectives. In P. B. Golden, H. Ben-Shammai, & A. Rona- Tas, The World of the Khazars: Selected Papers from the Jerusalem 1999 International Khazar Colloquium (pp. 7-57). Leiden: Brill. Goodman, M. (1987). The Ruling Class of Judaea: The Origins of the Jewish Revolt against Rome A.D. 66-70. Cambridge: Cambridge University Press. Grabbe, L. L. (2016). The Land of Canaan in. LONDON: Bloomsbury T&T Clark. Herzl, T. (1896). A Jewish State: An Attempt at A Modern Solution of the Jewish Question . (S. D’Avigdor, Trans.) New York: The Maccabean Publishing Co. Holub., R. C. (2016). Nietzsche’s Jewish Problem: Between Anti-Semitism And Anti-Judaism. Oxford: Princeton University Press. Hughes, J. (1990). Secrets of the Time: Myth and History in Biblical Chronology. (Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 66). Sheffield: Sheffield academic press. Hulse, E. (2000). The Story of the Puritans: Who were they? What did they accomplish? Why should we listen to them? Darlington: Evangelical Press. Kennedy, H. (2007). THE GREAT ARAB CONCWESTS: How the Spread of Islam Changed the World We Live In. USA: DA CAPO PRESS. Killebrew, A. E. (2005). Biblical Peoples And Ethnicity: An Archaeological Study of Egyptians, Philistines, and Early Israel, 1300-1100 B.C.E.: . Atlanta: Society of Biblical Literature. Kramer, S. N. (1963). The Sumerians: Their History, Culture, and Character. Chicago: University of Chicago Press. Landman, S. (1915). History of Zionism. London: The Zionist. Lewis, C. L., & Knell, S. J. (2001). The Age of the Earth: from 4004 BC to AD 202. London: Geological Society. Lumer, H. (1973). . . Zionisim: Its Role in World Politics. New York: International Publishers. Magness, J. (2012). The Archaeology of the Holy Land: From the Destruction of Solomon’s Temple to the Muslim Conquest. Cambridge: Cambridge Univesity Press. Maroney, E. (2010). The Other Zions: The Lost Histories of Jewish Nation. Lanham: MD: Rowman & Littlefield Publishers. Mason, S. (2016). A History of the Jewish War A.D. 66-74. New York: Cambridge University Press. Meshel, Z. (2011). “Yahweh and his Asherah”: The Kuntillet ‘Ajrud Ostraca, Did Yahweh Have a Consort? . In J. Corbett, & R. Bronder, Ten Top Biblical Archaeology Discoveries (pp. 52-67). Washington: Biblical Archaeology Society. Meyers , E. M., & Chancey, M. A. (2012). Alexander to Constantine: Archaeology of the Land of the Bible (Vol. 3). New Haven: Yale University Press. Mieroop, M. V. (2007). A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC (2 ed.). Oxford: Blackwell Publishing. Mor, M. (2016). The Second Jewish Revolt: The Bar Kokhba War, 132–136 CE. Leiden: Brill. Rajak, T. (2003). Josephus: The Historian and His Society (2 ed.). London: Gerald Duckworth. Redford, D. B. (1995). Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times (2 ed.). Cairo: The American University in Cairo Press. Richardson, P., & Fisher, A. M. (2018). Herod: King of the Jews and Friend of the Romans (2 ed.). London: Routledge. Roberts, A. (2011). Evolution: The Human Story. New York: DK Publishing. Rutherford, A. (2018). Humanimal: How Homo sapiens Became Nature’s Most Paradoxical Creature- A New Evolutionary History. New York: The Experiment. Sand, S. (2009). The Invention OF The Jewish People. (Y. Lotan, Trans.) London: Verso. Schaff, D. S. (1915). John Huss: His Life, Teachings And Death. New York: Charles Scribner’s Sons. Seward, D. (2009). Jerusalem’s Traitor: Josephus, Masada, and the fall of Judea. Philadelphia: DA CAPO Press. Sorek, S. (2008). The Jews Against Rome: War in Palestine AD 66-73. New York: Continuum. spector, s. (2009). Evangelicals and Israel: The Story of American Christian Zionism. Oxford: Oxford University Press. Weninger, S. (2011). The Semitic Languages: An International Handbook. Berlin: De Gruyter Mouton. Wilson, J. L. (1884). John Wycliffe: Patriot And Reformer “The Morning Star Of The Reformation”. New York: Funk & Wagnalls. Wood, B. (2005). Human Evolution: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. أحمد عيد. (1996). جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة. القاهرة: مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر. الوردات, م. أ. (2013, تشرين الأول). التقاويم. (س. قبيلات, Ed.) مجلة أفكار, pp. 101 – 111. جوناثان هيل. (2003). تاريخ الفكر المسيحي (الإصدار 1). (محمد حسن غنيم، المحرر، سليم اسكندر ، و مايكل رأفت، المترجمون) القاهرة: مكتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع. حنا جرجس الخضري. (1989). جون كلفن: دراسة تاريخية عقائدية. القاهرة: دار الثقافة. حنا جرجس الخضري. (ب س ن). المصلح مارتن لوثر حياته وتعاليمه: بحث تاريخي عقائدي لاهوتي. القاهرة: دار الثقافة. خزعل الماجدي. (1999). الآلهة الكنعانية. عمان: دار أزمنة. سامي سعيد الأحمد. (1984). ملحمة كَلكَامش. بيروت: دار الجليل. سمير مرقص. (2001). رسالة في الأصول البروتستانتية والسياسة الخارجية الأمريكية. القاهرة: مكتبة الشروق. عارف باشا العارف. (1951). تاريخ القدس (الإصدار 2). القاهرة: دار المعارف. عبد المنعم أبو بكر. (1985). مصر الفرعونية. (جمال مختار، المحرر) تاريخ افريقيا العام/ حضارات إفريقيا لقديمة، 2، الصفحات 71-102. عبد الوهاب محمد المسيري. (1982). الأيديولوجية الصهيونية: دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة. الكويت: عالم المعرفة. فراس السواح. (2003). تاريخ أورشليم: والبحث عن مملكة اليهود (الإصدار 3). دمشق: دار علاء الدين. لانكستر هاردنج. (1965). آثار الأردن. (ذوقان الهنداوي، المترجمون) عمان: اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة. ليث كاظم. (أيلول, 2017). معاداة السامية في فكر مارتن لوثر. (هادي الشيب، المحرر) مجلة العلوم السياسية والقانون، 1، الصفحات 257-286. محمد مؤنس عوض. (2007). الإمبراطورية البيزنطية: دراسة في تاريخ الأسر الحاكمة. القاهرة: عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية. نائل حنون. (2011). دراسات في علم الآثار واللغات القديمة (المجلد 1). دمشق: هيئة الموسوعة العربية. هانس فوروهاجن. (2017). فلسطين والشرق الأوسط بين الكتاب المقدس وعلم الآثار. (سمير طاهر، المترجمون) القاهرة: الكتب خان للنشر والتوزيع. ياقوت بن عبد الله الحَمَوي. (1977). معجم البلدان (المجلد 4). بيروت: دار صادر.