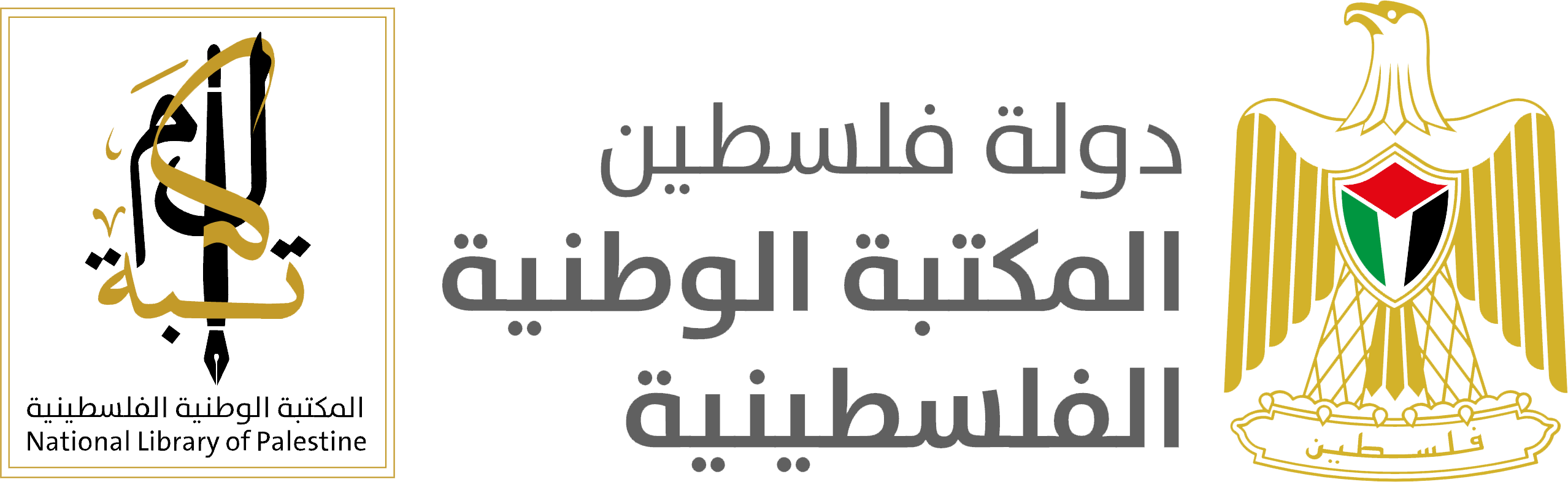الرُكام/ الأنقاض كأرشيف: عامان تبني غزة ذاكرة لا تموت
المكتبة الوطنية: برزت الصياغة المعاصرة لمفهوم (الإبادة الثقافية) في الوقت الذي شهدت الأرض اندلاع الحرب العالمية الثانية وويلات الإبادات الجماعية التي خلفت ملايين القتلى والمصابين وتركت بصماتها في الذاكرة الجمعية والنصوص التاريخية. ينطق مفهوم الإبادة الثقافية بتدمير مستهدف لجماعة بشرية أو استيعابها القسري في الثقافة المهيمنة. وبالمعنى الواسع للكلمة، فإن هذا (التدمير) يشتمل على السمات المادية والفكرية والعاطفية المميزة لجماعة ما كالفن والأدب وأنماط الحياة وطرق العيش وأنظمة القيم والتقاليد والمعتقدات.
غالباً ما توصف الإبادة الثقافية بأنها إبادة خفية، وبرغم عدم دمويتها، فإن عواقبها وخيمة مثل عواقب الإبادة الجماعية. فهي تهدف إلى تدمير الجماعة الإنسانية من خلال سياسات الاستيعاب أو التشتيت. ويمتد هذا التدمير عبر الأجيال ويحول دون نقل ثقافة الجماعة إلى الأجيال التالية، بحيث يمكن اعتبار آثاره مستمرة لفترات طويلة من الزمن. ولذلك فان الآلام تكون مضاعفة على مستوى الفرد والجماعة والإنسانية ككل.
في انحراف تاريخي، يكتب مارك نيكانيان أن الإبادة الجماعية ليست حقيقة، بل تتعدى ذلك بكونها دمار الحقيقة والأرشيف الذي يقوم بتوثيقها. يظهر هذا الطرح في السياقات التي يُستهدف فيها البشر والحجر على حد سواء، يتحول الركام إلى أكثر من بقايا مادية، يصبح أرشيفًا صامتًا يحفظ في طياته سرديات لم تُكتب بعد. في غزة، حيث تتعرض المدينة بكل معالمها الحضرية والشعب لمحاولات ممنهجة للمحو، لا يقتصر الاستهداف على الحياة فقط، بل يمتد إلى المنازل، المدارس، المساجد، الكنائس، الصور، الكتب، والموروثات التي تحمل ذاكرة الجماعة. يتم استهداف كل ما أنتجه الناس أو أنتج عنهم سعياً وراء حياتهم اليومية، من أجل نزع ملكيتهم الأصلانية مع الأرض.
أمام هذا الواقع، تُطرح أسئلة مُلحة: هل يمكن اعتبار الأنقاض أرشيفًا ووثيقة تاريخية يعتمد عليها؟ هل يمكن للدمار أن يُصبح وثيقة ذاكرة تُقاوم النسيان؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه "الأطلال" في بناء ذاكرة فلسطينية للصمود والنجاة وإعادة البناء الرمزي في وجه الإبادة؟
عندما تتكلم الأنقاض كوثيقة:
يُعرّف الأرشيف تقليديًا كمكان لحفظ الوثائق الرسمية والمرجعية، لكنه بات يُفهم اليوم بشكل أكثر اتساعًا. في سياق الإبادة، حيث تُستهدف حياة الناس، وأيضًا منازلهم، كتبهم، صورهم، وحتى ألعاب أطفالهم، يتحول الركام نفسه إلى أرشيف. فالأنقاض تحتفظ بما تبقّى من هوية الأسرة، من رائحة الحياة، من ترتيب المكان.
صورة حقيبة مدرسية تحت أنقاض مدرسة، أو دفتر طفل تفحّم نصفه، أو باب بيت لا يزال يحمل أسماء أطفاله — هذه ليست مجرد "بقايا"، بل وثائق مادية للذاكرة، تثبت أن هذا المكان لم يكن مجرد هدف عسكري، بل بيتًا، وشارعًا، وحياةً، تم تكثيف القوة ضده من أجل نزع زمانية العلاقة بين الناس وأرضهم، وما تقوم به الذاكرة من إعادة انتاج العلاقة بين الواقع المعاش وذكريات الحياة بتفاصيلها البسيطة.
في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء، وصعوبة الوصول إلى الإنترنت، والرقابة الإعلامية المشددة، يعتمد الفلسطينيون على توثيق فردي وشعبي للدمار. تظهر فيديوهات على وسائل التواصل تُظهر لحظات القصف وما بعده، ليست فقط كنوع من التوثيق السياسي، بل كفعل أرشفة. فالتصوير في لحظة القصف ليس سلوكًا عفويًا، بل ممارسة ثقافية لمواجهة المحو. الناشط، الصحفي، الطفل الذي يحمل هاتفه وسط الركام، كلهم يُنتجون أرشيفًا شعبيًا لا رسميًا، لكنه أكثر صدقًا وقربًا من الواقع، لأنه ينقل الرؤية من عين الضحية لا من عين الراوي الدولي. ومتحرراً من سياسات الواقعية والمنهجية العلمية والحياد الموضوعي.
ذاكرة الركام وهوية الصمود:
ذاكرة الشعوب لا تُبنى فقط على النصر والشهادة والمذكرات للقادة والأبطال، بل أيضًا على الألم. في الحالة الفلسطينية، حيث يستهدف الاحتلال الهوية والذاكرة والثقافة، تصبح إعادة بناء الذاكرة من الركام فعلًا سياسيًا وثقافيًا مقاومًا. ليس الهدف فقط توثيق ما حدث، بل إعادة كتابة التاريخ من موقع الحق في العدالة والحرية والظلم المستمر منذ أكثر من قرن.
كل بيت يُقصف، كل شارع يُدمَّر، يدخل ضمن سردية أوسع تتجاوز الفرد إلى الجماعة. الركام هنا يُعيد صياغة الهوية الجمعية، ويُحول "المأساة" إلى رواية صمود جماعية. يتحول المكان المدمر إلى "نصب رمزي" يحمل ذاكرة لا تموت، تمامًا كما تحوّلت خيام النكبة إلى رموز دائمة للشتات والعودة، وتتكثف من خلالها صورة الانتظار كفعل صمود وحق جمعي في العودة الى الأرض المنشودة والمرغوب بها الى الأبد.
من الركام إلى العدالة: الأرشفة كفعل قانوني
الركام لا يتحدث فقط بلغة الذاكرة، بل يمكن أن يكون شاهدًا في ساحة العدالة. في السنوات الأخيرة، بدأت منظمات حقوق الإنسان تعتمد على أدلة مادية من الركام لإثبات استخدام أسلحة محظورة، أو استهداف المدنيين عمدًا.
المواد المتفجرة، زاوية الضربة، بقايا الجثامين، وحتى طريقة انهيار المباني – كلها تتحول إلى أدلة قانونية في محاكمات محتملة. من هنا، فإن تصوير الأنقاض وتوثيقها بدقة ليس مجرد عمل عاطفي أو إنساني، بل هو عمل سياسي حقوقي بامتياز. وهو فعل انساني من أجل مقاومة النسيان، ومنع ضياع الحق في زمن التسويات السياسية، ومن أجل عالمية الحق الفلسطيني في العدالة.
الفن من الركام: الذاكرة البصرية والمقاومة الثقافية:
لا تقتصر الذاكرة على الوثائق أو الصور، بل تتجلى أيضًا في الإنتاج الثقافي والفني. كثير من الفنانين الفلسطينيين استخدموا قطع الركام في أعمالهم، أو صوّروا جداريات على الجدران المهدّمة، أو صنعوا تماثيل من بقايا الحديد والخرسانة.
هذه الأعمال ليست للعرض فقط، بل تمثل محاولة لاستعادة السيطرة على السردية، ولإعادة تشكيل ذاكرة جمعية ترى في الأنقاض رمزًا للبقاء لا للهزيمة. كما أن استخدام الأنقاض في النصب التذكارية يربط الذاكرة بالمكان، ويمنع محو الجريمة عن طريق إعادة بناء البعد الإنساني للدمار.
الركام لا يُمحى:
في غزة، حيث تتكرر الإبادات، يتم إنتاج الركام باستمرار، هذا لا يعني أنه متشابه أو ميت. بل يحمل كل ركام رواية فريدة، لحياة قُطعت، وبيت تهدّم، وحلم صُودر.تحويل الركام إلى أرشيف هو فعل مقاومة ضد الصمت والنسيان، وضد الخطابات التي تُجرِّد الفلسطيني من إنسانيته. هو دعوة لقراءة الألم لا كخاتمة، بل كجزء من سردية أوسع للنجاة والصمود.
أن تتحول الأنقاض إلى ذاكرة، فهذا يعني أن الضحايا لم يُمحَوا، بل أصبحوا سردًا مقاومًا، يُكتب بالحجر والصورة والدم، ويتحوّل إلى دليل دامغ على أن الشعب الذي يُستهدف بالإبادة، لا يُمحى. بل يعطي من تبقى دفعة من الإنتظار المحكوم بالأمل الى مستقبل أفضل الى نهاية مرغوب بها، هي نهاية الاحتلال.
إن مفهوم "الركام/ الأنقاض" يساعدنا على العودة الى قراءة المشهد من خلال سلوكياتنا، وكيف نتكيف مع واقعنا، والذي من خلاله يمكن الخروج بأفق انساني، خارج سيطرة القوة بمعناها الواسع. ان حرب الابادة المستمرة على غزة هي حرب تاريخ الزمن الراهن الذي سيرافقنا الى زمن قادم، سيعمل على تغيير نظرتنا لوجودنا ولطرقنا في التعبير عن وجودنا وصمودنا وانتظارنا. ان هذه المواد التي يتم مراجعتها من الركام تساعدنا للمستقبل، تساعدنا لانتاج ذوات مختلفة وفعل صمود آخر.